سمير أمين: الإسلام السياسي والامبريالية العالمية
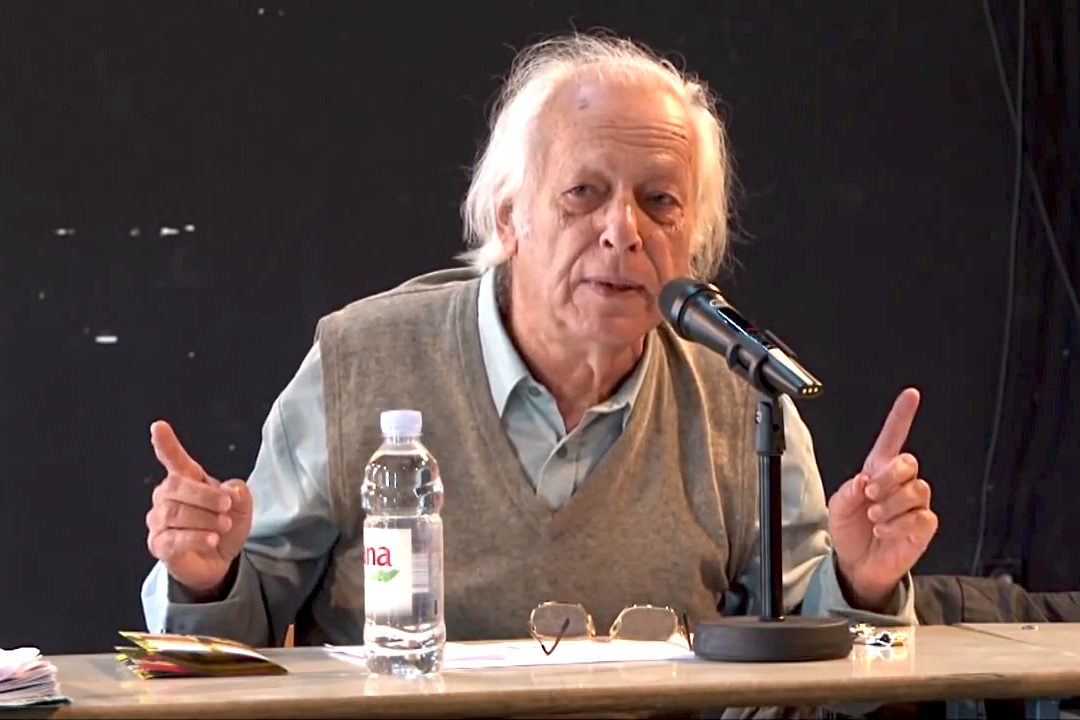
المقدمة
إن التحليل العلمي لأسباب نشوء ظاهرة الإسلام السياسي في العشرينيات من القرن المنصرم، والصعود الكبير لهذه الظاهرة مع بداية الثمانينيات من نفس القرن، هو الذي يفتح الطريق نحو اجتراح الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة، والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات العربية، أو حتى دفع الفاعلين الأساسيين في هذه الظاهرة على تطوير أطروحاتهم بحيث تسمح لهم بإجراء توافقات مع التيارات السياسية الأخرى في المعارضة كما هو الحال عليه في تونس بعد ثورة الياسمين، حيث حكومات التوافق بين إسلاميي حزب النهضة والتيارات الأخرى الفاعلة في الساحة السياسية التونسية.
إن القراءة الصحيحة لظاهرة الإسلام السياسي باستعمال المنهجية التعددية هي التي توصلنا الحلول المناسبة للتخفيف من تأثيرها على الحياة الاجتماعية والسياسية. بينما يرى المحللون الماركسيون بالخصوص، واليساريون على العموم، أن صعود ظاهرة الإسلام السياسي سببها الأول والأساسي الظروف الاجتماعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الطبقات الشعبية، وبحسب ماركس إن الدين هو تنهيدة المضطهد، هو قلب عالم لا قلب له. لذلك، فإن البؤس الأرضي هو مصدر سعادة السماء، ودون مواجهة هذا البؤس الأرضي ستبقى السماء هي الملاذ الوحيد. وسيبقى التراث يحتوينا، ولا نحتويه، يستعيدنا ولا نستعيده، يكون ملاذنا، ولسنا ملاذ تاريخيته فلا فائدة بالنسبة لليساري عموماً من التطرق إلى الدين ونصوصه ونمط التدين للكشف عن أسباب الظاهرة، يكفي أن نحقق العدالة الاجتماعية لكي تنتفي ظاهرة الإسلام السياسي، إن لم يكن ظاهرة الدين كلها، وأيضاً الظاهرة المناهضة له، أي الإلحاد الذي هو الوجه الآخر للتدين في الفكر اليساري – الماركسي.
بالنسبة لنا، فإن القراءة اليسارية التي تعتمد المقاربة الاقتصادية – الاجتماعية غير كافية لفهم ظاهرة الإسلام السياسي، وظواهر اجتماعية أخرى، فإهمال الجوانب الثقافية والأيديولوجية والنفسية لظاهرة الإسلام السياسي، أو اعتبارها أسباب ثانوية ملحقة سببياً بالبنية التحتية والنمط الاجتماعي الإنتاجي القائم، يولد الكثير من المآزق الإيبستمولوجية أو المعرفية في الفهم، وبالتالي لا يفتح الطريق أمام الحلول الناجعة لتخفيف الاحتقانات في المجتمعات العربية.
يتَبّع س. أمين في مقالته الإسلام السياسي في خدمة التوسع الامبريالي*، نمطاً من المنهجية التحليلية للظواهر الاجتماعية والسياسية – وهنا يتعلق الأمر بظاهرة الإسلام السياسي – تُسمى منهجية (إما وإما) والثالث مرفوع؛ هذا المنطق الثنائي التخارجي يشبه النزعة المانوية، إما الخير أو الشر؛ أي أن ظاهرة الإسلام السياسي، إما أن تخدم قضية تحرر الشعوب من ربقة الرأسمالية الامبريالية العالمية والمعولمة، وإما تكون ظاهرة تصب في مصلحة الامبريالية العالمية التي تسعى لدوام سيطرتها على العالم. ومن المعروف أن هذه المنهجية التحليلية التي تعتمد الثنائيات التناقضية، أصبحت متروكة من قبل معظم الدارسين للاجتماع والتاريخ نظراً لعدم كفايتها المنهجية في شرح تعقد الظاهرة الاجتماعية وتعدّد مُسبباتها وتداخلها مع بعضها بعضاً.
من الممكن الجزم بعدم وجود قوانين وميول واتجاهات تحكم الظاهرة الاجتماعية، مثلما تحكم القوانين الفيزيائية والطبيعية والكيميائية والبيولوجية عالم الطبيعة (بالرغم من أن مؤسس علم الاجتماع أوغست كانت أطلق عليه في البدء بـ الفيزياء الاجتماعية)، وذلك نظراً لفرادة الظاهرة الاجتماعية وعدم القدرة على تكرارها في التجربة. من ناحية أخرى، يمكننا القول بأن الظاهرة الاجتماعية لا تسبح في عالم من الفوضى، ونستطيع الوصول إلى تفسيرات مقبولة، باعتماد الموضوعية، والتحليل العلمي، والحيادية، والمنهج التعددي، والقدرة على الفهم.
تنقسم النظريات الاجتماعية والتاريخية بالنسبة للفلسفة المادية الديالكتيكية إلى قسمين أساسيين:
أولاً: الاتجاه المادي الذي يفسر الظواهر الاجتماعية والتاريخية من خلال العوامل المادية، كالعامل الاقتصادي كما فعل ماركس في المادية التاريخية، وهو الاتجاه العلمي.
ثانياً: الاتجاه المثالي الذي يفسر تلك الظواهر من خلال عومل مثالية، كالأفكار والمُثل والسياسة والعامل الديني والقومي والاثني. كما فعل ماكس فيبر في كتابه ((الرأسمالية وروح البروتستانتية))، واعتبر الماركسيون كتابه تعبيراً عن النزعة المثالية في التفسير، أي أنها تقلب العوامل التابعة إلى عوامل سببية في الظاهرة الاجتماعية.
بمعنى، آخر التفسير العلمي في الاجتماعيات الماركسية هي التي تخضع البنية الفوقية (البنية المثالية) للبنية التحتية (أي البنية المادية أو مستوى الإنتاج والعلاقات بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج).
إن التفسيرات المادية البحتة، والتي ترى في الدين تغطية لمصالح الحكام والطبقات المستغلة، غير قادرة على تفسير حيوية التاريخ المعقدة، وكذلك تعجز التفسيرات المثالية البحتة التي تهمل العناصر الاقتصادية والاجتماعية عن أن تقدم تفسيرات مقنعة للتاريخ.
والاتجاه التفسيري الغالب في النظرية الاجتماعية، هو النظر إلى العاملين (المادي والمثالي) بشكل ديناميكي مُتفاعل، متخلصاً من الميكانيكية والانعكاسية التي تطبع مفهوم البنية التحتية والبنية الفوقية الماركسي الذي سيطر بالخصوص في النصف الثاني من القرن الماضي في أوساط الإنتلجنسيا في العالم على العموم، وفي الغرب على الخصوص.
ويمكن أن يُسيطر أحد العوامل في فترة تاريخية ما أكثر من العامل الآخر. فالعامل الديني كان هو المُقرّر الأساسي في القرون الوسطى، وهو ما زال يلعب دوراً غالباً في كثير من مناطق العالم المتخلفة. وإذا استعملنا المصطلح الذي نحته عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو أي الرأسمال الرمزي، نجد في المجتمعات ما قبل الرأسمالية (التقليدية)، أن أهمية الرأسمال الرمزي تفوق أهمية الرأسمال الاقتصادي، بينما يسيطر العامل الاقتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة التي عملت قطيعة مع تورايخها السابقة، وانطلقت في رحاب الحداثة السياسية والاجتماعية. إن العامل الديني في أوروبا لا يمكن اعتباره عاملاً غالباً في التحليل الاجتماعي، وإن حلّ محله الفكر والثقافة والأيديولوجية على الأخص، كرساميل رمزي لها كثير من الفاعلية في المجتمعات الغربية الحديثة.
إن الصراع – بحسب سمير أمين – هو صراع اقتصادي بامتياز، ويمكن تشخيصه في الغرب منذ قيام الرأسمالية كتشكيلة اجتماعية أساسية حتى الآن، وهو صراع قائم بين الرأسمال والحكومات والأسواق التي تعمل لصالح الرأسمالية وبين القوى الحية في المجتمعات الأوروبية والتي تتبنى المنظومة الماركسية في تفسير نشأة وتطور ومستقبل الرأسمالية كتشكيلة اجتماعية تاريخية يجب أن يجري تجاوزها مع تطور قوى الإنتاج نحو المجتمع الذي يحقق نهاية الطبقات والتناقضات الكبرى في المجتمع. أما بعد تحول الرأسمالية إلى طور الامبريالية، فقد أخذ هذا الصراع – حسب سمير أمين – بعداً عالمياً بين القوى الرأسمالية العالمية في الغرب (المركز) وشعوب العالم الثالث المستغَلة (الأطراف)، وتلعب القوى اليسارية الجذرية في الغرب دورا إيجابيا لصالح حسم الصراع نحو وجهة تقدمية تزيل كل أسباب الاستغلال التي تتسبب به الامبريالية في العوالم غير الغربية، وتمنع تطورها.
ولقد طرح س. أمين نظريته حول الاستقطاب الرأسمالي، في أطروحته للدكتوراة عام 1957 تحت عنوان ((الآثار البنيوية للدمج العالمي للاقتصادات ما قبل الرأسمالية)). وخلاصة هذه الأطروحة: أن البلدان ما قبل الرأسمالية ليس عندها خيار من أجل التطور سوى فك العلاقة مع المركز الرأسمالي، واتبّاع الطريق الاشتراكي. أما الخيار الرأسمالي، فهو الطريق المسدود نحو التنمية في العالم الثالث، لأنه أدى وسيؤدي إلى استتباع اقتصاديات هذه الدول للمركز الرأسمالي المتقدم المتمثل في الثالوث المهيمن – الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان، وبالتالي، سوف يبقيها في حالة تخلف دائم نتيجة عملية الاستتباع هذه[1].
يركز س. أمين بشكل قوي على عامل التبعية التي تشجع على تكوين نخبة برجوازية محلية مقطوعة الصلة عن الجسم الرئيسي من السكان وعديمة الحساسية لما يحرّك الجمهور الواسع من آمال وآلام. والسبب في ذلك هو أنه في حين أن الرأسمالية كانت تحتاج في أوروبا حتى تنتصر على الإقطاعية إلى الديموقراطية، خاصة وأنها لم تكن تخشى التدخلات الخارجية، فإن الرأسمالية التابعة تجد نفسها محشورة بين نوعين من الضغط: ضغط التوسع والعدوان الاستعماري من جهة، والمعارضة القوية والدائمة للجماهير الشعبية من جهة أخرى. وهكذا، بما أن البرجوازية المحلية غير قادرة على الجمع في الوقت نفسه بين التنمية المستقلة والمتمحورة على الذات والاندماج في السوق الرأسمالية العالمية، كما كان عليه الأمر بالنسبة للرأسمالية المركزية في أوروبا، فهي مدانة، بسبب عبوديتها لهذه السوق العالمية ومقتضيات الاندماج فيها، إلى أن تبقى شمولية واستبدادية[2].
ويوجّه المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز، نقداً لاذعاً لمنظومة التبعية عند سمير أمين، على اعتبارها “أصولية” في مبناها المعرفي. ويشبّه نظرية التبعية بفكرة عدم شرعية الحداثة عند الأصوليين، على أساس أنها أتت في سياق الغزو الاستعماري للشرق وتفكك الإمبراطورية العثمانية. فكما أن الأصوليين يشككون في أصالة ميلاد تلك الفكرة (فكرة الحداثة)، وفي شرعيتها التاريخية أو الوجودية، بحسبانها وُلدت بعملية قيصرية من خارج ولم تنشأ في سياق ثورة ثقافية ذاتية في جوف المعرفة العربية – الإسلامية الموروثة. كذلك، يفسر س. أمين ميلاد علاقات إنتاج رأسمالية في المجتمع العربي في القرن التاسع عشر، حيث نُظر إليها كعلاقات مفروضة من خارج بفعل عملية الرَّسملة الاستعمارية وليس نتيجة تفكيك بُنى الإنتاج قبل الرأسمالية. وهو ما قاد إلى نظرية التبعية للمتروبول الامبريالي[3].
لذلك، فإن س. أمين يعتبر أن كل القوى السياسية التي تطالب بالرأسمالية، هي قوى تريد أن تربط مجتمعاتها بالمركز الرأسمالي. يشكل هذا الرأي الحصري، إدانة سياسية لكل القوى “البرجوازية الوطنية” و”الليبرالية” و”اليسارية الديموقراطية”، عندها يكون الإسلام السياسي – الذي يدافع عن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويقف على يمين اليمين بالنسبة للتشكيلات السياسية السابقة – يعمل في “خدمة التوسع الامبريالي” ويشكل، بالنتيجة، إعاقة لحركة التحرّر والتقدم الثورية.
يقول س. أمين في مقالته ((الإسلام السياسي في خدمة الإمبريالية)) ما يلي: ((وعلى أرضية القضايا الاجتماعية الحقيقية يضع الإسلام السياسيّ نفسه في معسكر الرأسمالية التابعة والإمبريالية المهيمنة. فهو يدافع عن مبدأ الطابع المقدس للملْكية، ويشرعن اللامساواة وجميع متطلبات إعادة الإنتاج الرأسماليّ. ويعتبر الدعم الذي قدمه الإخوان المسلمون في البرلمان المصريّ (العام الماضي) للقوانين الرجعية التي تعزز حقوق مالكي العقارات على حساب حقوق المزارعين المستأجرين (وأغلبيتهم من الفلاحين الصغار) مجرد مثال واحد من بين مئات الأمثلة على ذلك. والواقع ليس ثمّة مثال حتى على قانون رجعيّ واحد في أيّ من الدول الإسلامية تعارضه الحركات الإسلامية. أكثر من ذلك؛ إنّ مثل هذه القوانين يتمّ سنّها بالاتفاق مع قادة النظام الإمبرياليّ. فالإسلام السياسي ليس ضدّ الإمبريالية، حتى وإن كان أتباعه يفكرون على غير هذا النحو! وهو حليف ثمين للإمبريالية، وهذه المعلومة جرى إدراكها مؤخراً. وهكذا يسهل فهم لماذا كان الإسلام السياسيّ يضع اعتماده دائماً على الطبقة الحاكمة في المملكة العربية السعودية وباكستان. حتى أن هذه الطبقات كانت من أكثر المروّجين له منذ البدايات. كما دعّم الإسلام السياسيّ بقوّة كلاّ من البورجوازيات الكومبرادورية المحلية والأثرياء الجدد والمستفيدين من العولمة الإمبريالية الراهنة. وقد تخلّى مؤخراً عن مناهضة الإمبريالية واستعاض عنها بموقف مناهضة الغرب (الذي يعني غالبا مناهضة المسيحية)، والذي من الواضح أنه يقود المجتمعات إلى طريق مسدود، لكنه لا يشكّل عقبة أمام انتشار الامبريالية وسيطرتها على النظام العالميّ)).
ينحو س. أمين بهذا المنطق الثنائي المانوي الذي يعتمد الثنائيات المتقابلة، والذي يميز الأيديولوجيات الحديثة المغلقة، منحىًّ إقصائياً. فإما أن كون مع الطريق الاشتراكي، وإما توضع في خانة الإمبريالية. فالقضية بحسب المنطق الذي يسير عليه المفكر الماركسي، إما أن تكون صادقة بشكل مطلق، وإما كاذبة بالمطلق نفسه، والثالث مرفوع حسب المنطق الارسطي. أي لا يوجد قيمة ثالثة يمكن أن تمتح من القضيتين المتقابلتين، أو (لا وسط بين النفي والإثبات) بلغة الفقهاء، أو “منزلة بين المنزلتين” كما يقول المعتزلة في قضية الإيمان والكفر. والثالث المرفوع هنا هو الإسلام السياسي الذي يحاول أن يدين الشرق والغرب، أي الخيار الاشتراكي والخيار الرأسمالي، فهو يضع نفسه حسب س. أمين في خدمة التوسع الإمبريالي، لأنه ليس هناك خيار ممكن خارج هاذين الخيارين.
على الأقل، يمكننا القول بأن س. أمين يدين الهرطقة أو الجنون الذي ظهر منذ عقدين في الغرب بين أوساط اليسار الراديكالي والمُسمى أحياناً باليسار الإسلامي، والذي يرى في المسلمين عموماً – وليس فقط المهاجرين إلى ديار الغرب – البروليتاريا الجديدة في النضال ضد الإمبريالية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية، ويأمل بأن تحل الماركسية كديانة علمانية تحمل الرجاء الدنيوي مكان الإسلام الدين القروسطي الذي هو ((هو قلب عالم لا قلب له، مثلما هو روح وضع بلا روح، إنه أفيون الشعب))، وهي العبارة الشهيرة لماركس، والتي وردت في ((نحو نقد فلسفة الحق الهيجلية)) (1844).
حين يشبه س. أمين الحركات الأصولية الإسلامية بالاتجاهات المحافظة الرجعية التي نشأت بعد الثورة الفرنسية، فهو يجانب الصواب، ويُخطئ بالسياقات التاريخية المختلفة. إن المحافظة كمصطلح ظهر في إنكلترا أعرق وأقدم ديموقراطية في العالم لا يمكن مماهاته بالأصولية، سواء المسيحية أو الإسلامية، هو تيار يؤمن بالإصلاح التدريجي ويرفض بالخصوص الطرق الثورية والأيديولوجية التقدمية أو الحداثوية التي تعتبر كل شيء جديد عظيم ويجب الأخذ به. فالحركات التي قادها فكرياً إدموند بيرك البريطاني (1729-1797) وجوزيف دو ميستر الفرنسي (1753-1821) بالخصوص، والتي عارضت التمزقات والقطائع التي أحدثتها الحداثة، أرادت الرجوع بأوروبا نحو “المحافظة” والتقاليد الملكية في الإصلاح التدريجي الذي كان خصوصية بريطانية ولم تنجح في فرنسا بسبب تأخر الملكية الفرنسية عن الإصلاح. لكن، هذه الحركات المحافظة لم تنجح، لأن تيار الحداثة في أوروبا كان جارفاً، وشمل معظم الدوائر الاجتماعية، ولم يقتصر فقط على التحديث الرأسمالي للاقتصاد والانتقال به من اقتصاد زراعي ذي طابع إقطاعي، إلى اقتصاد رأسمالي حديث.
إذن، يمكن اعتبار الحركات الإسلامية المعاصرة في العالم العربي والإسلامي، بمثابة ردود أفعال عنيفة وحادة ضد الحداثة الوافدة، والتي لم تستطع خلال قرنين ونيف سوى أن تلامس سوى “السطح” من المجتمعات العربية والإسلامية. يسمي سيرج لاتوش عالم الاجتماع الفرنسي هذه الظاهرة بالتحديث دون حداثة. بمعنى التغيّر والانقلاب العنيف في المشهد الاقتصادي والاستهلاكي من دون أن يترافق مع حداثة سياسية تتشمل قيام المؤسسات الديموقراطية والمجتمعات المدنية، وكذلك الحداثة الفكرية والدينية التي تقطع مع اللاهوت القروسطي العتيق، والممارسات الغيبية والسحرية، وبالخصوص تحرر واستقلالية المرأة. وهذا ما يفسر ضعف التيارات الديموقراطية – اليسارية أو غير اليسارية – في العالم العربي والإسلامي، رغم كل هذه “الثورات” القومية والاشتراكية التي حدثت في بداية الخمسينيات، ابتداءً من الثورة المصرية في الثالث والعشرين من تموز 1952 ووصولاً إلى الثورتين الليبية والسودانية عامي 1969 و1970. وهو الأمر الذي لا يمكننا تفسيره إلا في عمق تأخر الثقافة السياسية وقوة التقليد الديني المتمثل في المؤسسات الاجتماعية وأولها المؤسسة الدينية الرسمية، وليست حركات الإسلام السياسي سوى الإيمان بإمكانية إعادة حركة التاريخ إلى الوراء عن طريق تحويل فترة دولة النبيّ والخلافة التي سميت بالراشدة إلى نموذج مثالي “متخيل” يمكن تحقيقه في الزمن الراهن، والثورة على الدولة القائمة والمؤسسة الدينية الرسمية التي ما زالت تحتفظ في تعاليمها بكل المرجعيات الكلاسيكية لأدبيات السياسة الشرعية، والتي ترفض الخروج عن الحاكم – مهما كان جائرا – خوفاً من الفتنة.
نشوء الظاهرة الإسلاموية
من أنتج الإسلام السياسي في الثلث الأول من القرن العشرين؟
ولماذا أصبحت الحركات الإسلاموية هي المعارضة الأساسية ضد السلطات الطغيانية في العالم العربي منذ الربع الأخير من القرن المنصرم؟.
حسب تحليلنا، إن البنية الإيبستمولوجية الحاكمة لهذه التيارات الإسلاموية لا تختلف عن تلك التي كانت متحكمة في العالم العربي والإسلامي حين تم الهجوم على بدايات التفكير النقدي الحر، والذي تمثل في كتابي ((الإسلام وأصول الحكم)) (1925) للشيخ الأزهري علي عبد الرازق و((في الشعر الجاهلي)) (1926) لعميد الأدب العربي طه حسين، وإن الاختلاف الوحيد بين الإسلام السياسي والتقليد الديني المتحكم إلى يومنا هذا هو (أي المؤسسة الرسمية والتي نموذجها الأمثل هي مؤسسة الأزهر)، والسائد والمهيمن اجتماعيا، هو في الثورية السياسية للأول، والتي يعتبرها التقليد الديني الإسلامي بمثابة الخروج عن الحاكم وإحداث الفتنة داخل “الجماعة” الواحدة[4].
يعتقد التيار الماركسي أن الاستعمار البريطاني هو الذي دفع إلى نشوء ظاهرة الإسلام السياسي المتمثلة بجمعية الإخوان المسلمين عام 1928، وأن المركز الإمبريالي العالمي اندفع في تغذيتها لمحاربة الأنظمة الشعبوية التي تعارض “مصالح الإمبريالية المهيمنة” حسب تعبيرات س. أمين. والمستغرب أن أكثر المعارضين لهذا التفسير السياسي المؤامراتي، هم أصحاب الشأن أنفسهم. وليس غريباً القول، بأن هذا التفسير يتجه إلى اعتبار كل أمور الداخل عجينة في يد الخارج، يوجهها الخارج لمصالحه الخاصة. بحسب هذا الحليل يصبح الاستعمار غير خاضع لأوضاع داخلية مضطربة تولد الضعف في كافة مفاصله الاجتماعية، حيث سماها المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي بـ القابلية للاستعمار[5]، وإنما تطور الرأسمالية نحو مرحلتها الإمبريالية وعولمة نظام السوق والتجارة الحرة التي يتحكم فيهما (المركز).
مما لا شك فيه أن رفض التيارات الأصولية السلفية للإصلاحات الاجتماعية ذات الطابع الاشتراكي على يد السلطات “الثورية” الجديدة في مصر وسورية والعراق، شكل حافزاً سياسياً لدى الغرب لاعتبار هذه التيارات الإسلامية حليفاً ممكناً في الصراع مع المعسكر الشيوعي والأنظمة الثورية أو الشعبوية في العالم العربي. إن عداء هذه التيارات الإسلامية للأنظمة القومية ذات التوجه الاجتماعي الاشتراكي وضعها في موقعين أساسيين من السياسة الدولية:
الأول، كتيار معادي للقومية العربية، على اعتبار أن القومية تناهض الطروحات الأممية الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك، كانت معظم هذه التيارات القومية تتبنى الاشتراكية كمنهج عمل اقتصادي واجتماعي.
الثاني، كتيار ضاغط على سياسات الاتحاد السوفياتي السابق في شرقي المتوسط.
إن التيارات السلفية الأصولية لم تكن حليفة للغرب، ولكن عبر الموقعين السابقين اللذين وضعت نفسها فيهما، دعمت سياسات الغرب بشكل أو آخر. حيث جسدت إعاقة مستمرة لتنفيذ السياسات التي تساعد على نفاذ الاتحاد السوفياتي السابق إلى المياه الدافئة، أي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. وربما نظر الغرب، في وقت من الأوقات، خلال صراعه مع الاتحاد السوفياتي والكتلة الشيوعية في أثناء الحرب الباردة، على أن هذه الحركات الإسلامية قد تكون شريكاً طبيعياً له، نظراً لعدائهم “للملحدين الشيوعيين” وتأييدهم الثابت للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج[6].
لكن، هل يمكن اعتبار هذا التلاقي الظرفي في المصالح تحالفاً سياسياً؟
وهل يمكن، من ناحية أخرى، إرجاع أسباب نشوء الحركات الإسلامية إلى هذا العامل الخارجي؟
يمكن، اعتبار هذا العامل الخارجي، وبالخصوص، تسهيل ودعم الولايات المتحدة الامريكية للجهاديين الإسلاميين في الحرب في أفغانستان، من العوامل التي ساعدت على تضخيم الظاهرة الإسلاموية، وبالخصوص التيارات السلفية الجهادية منها، بعيداً عن إمكانية خلقها وتصنيعها من الألف إلى الياء.
تميل الكثير من التحاليل الرصينة على توجيه الاتهام نحو الأنظمة الاستبدادية الشعبوية ذاتها في العالم العربي بصورة خاصة – والتي تحولت فيما بعد إلى أنظمة طغيانية مافيوزية فاسدة – والتي اعتبرها س. أمين في مقالته ((الإسلام السياسي والإمبريالية العالمية)) ذات طابع “حداثوي” و”علماني”. فهذه السلطات الشعبوية بإلغائها المجتمعات المدنية، وتصحيرها للحياة السياسية لحساب الحزب الأوحد القائد، وإلغاءها كل معارضة مدنية في المجتمع، جعلت “المسجد”، وبالتالي، الثقافة الدينية التقليدية – والتي تمتح من نفس المعين الإيبستيمي الأصولي السلفي – هي الصوت الوحيد في المجتمع، وبخاصة بعد تصفية كل التيارات الليبرالية واليسارية، سواء عن طريق التضييق أو السجون أو النفي إلى خارج الأوطان.
يقول السوري ياسين الحافظ عن نظام جمال عبد الناصر – والكلام اللاحق يصلح لكل الأنظمة الشعبوية الطغيانية في العالم العربي – في كتابه ((الهزيمة والأيديولوجية المهزومة)): في الوقت الذي كان فيه النظام الناصري يحصد الإخوان المسلمين سياسياً، كان يزرعهم ثقافياً وأيديولوجياً، الأمر الذي ألق به في سلسلة اختناقات انتهت بضربة الخامس من حزيران القاصمة[7].
ولا ننكر أن سياسات الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة الامريكية خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، حضنت وشجعت التنظيمات الإسلامية للوقوف في وجه المد الشيوعي في العالم الثالث، وبالخصوص أثناء الغزو السوفياتي لأفغانستان. وكانت هذه السياسات الخرقاء هي أحد العوامل التي دفعت إلى انفجار الأصوليات، وبالخصوص في أفغانستان وباكستان. لكن، تبقى الأسباب الأساسية لظاهرة الإسلام السياسي والراديكالي كامنة في العوامل الداخلية، في داخل النطاق الديني الإسلامي، وأيضاً في الممارسات القمعية الوحشية للسلطات الشعبوية (مصر، سورية، العراق، ليبيا، السودان)، وكذلك للممارسات الاستبدادية للنظم التقليدية (دول الخليج في معظمها، وبالخصوص المملكة العربية السعودية والتي تنافس النظم الشعبوية العسكرية في وحشيتها وبطشها للمعارضين). فخلف الاختلاف الشكلي في المظهر السياسي، تتشابه كل السلطات والأنظمة العربية، وبشكل مدهش، في جميع الميادين. فمن الناحية الاقتصادية، مارست كل البلدان العربية سياسات اقتصادية متشابهة، وهي تغليب الدولة الرعوية والاقتصاد الريعي بدلاً من تشجيع الإنتاج الاجتماعي الفعلي، مما كرس نوع من الاتكالية، والابتعاد عن الفعالية الاقتصادية الاجتماعية الإنتاجية التي تساهم في صنع التاريخ بإنتاجه من خلال البنية التحتية. أما في الجانب السياسي، فقد احتكرت هذه السلطات العربية ممارسة السياسة في الحزب الواحد أو حاشية الأمير أو الملك أو العشيرة والطائفة والعائلة القريبة؛ وبقي الشعب بفئاته وشرائحه المختلفة مُغيباً ومبعداً عن العملية السياسية، حتى وصلنا إلى انتشار شعور من العدمية السياسية بين الأفراد. وبغياب الأحزاب، فقد المجتمع بوصلته، مما قوّض كل إمكانية لتقدم التاريخ، سوى عن طريق بعض الحركات “الاعتمادية” بحسب مصطلحات علم الكلام الإسلامي. وحركة الاعتماد حسب وصف المتكلم المعتزلي إبراهيم النظَّام (777-836) هي السكون المتحرك، أي حركة الشيء في نفس موضعه، بالمقارنة مع حركة النقلة، أي الانتقال من مكان إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى.
حركة الإخوان المسلمين
يعتبر س. أمين في مقالته أن حركة الإخوان المسلمين هي صناعة بريطانية، بمساعدة الملكية في مصر: ((إن تاريخ الإخوان المسلمين معروف للجميع. فقد نشأت هذه الحركة في العشرينيات من القرن الماضي على أيدي البريطانيين والنظام الملكي بهدف قطع الطريق أمام حزب الوفد الوطني الديموقراطي العلماني. ويعلم الجميع أيضاً أن السادات ووكالة المخابرات الامريكية نظّما عودة جماعية لعناصر الحركة وجمهورها من أماكن لجوئهم في السعودية بعد وفاة جمال عبد الناصر. ونحن جميعاً على بيّنة من تاريخ حركة طالبان التي شكّلتها وكالة المخابرات المركزية الامريكية في باكستان لمحاربة الشيوعيين الذين فتحوا مدارس للجميع، ذكوراً وإناثاً. بل إنه معروف جيداً أن الإسرائيليين ساندوا حماس في البداية من أجل إضعاف التيارات العلمانية والديموقراطية في المقاومة الفلسطينية)). ويضيف لاحقاً ((بأن الإسلام السياسيّ جرى تخليقه من خلال العمل المنهجيّ للإمبريالية، المدعومة – بالطبع – من قبل القوى الرجعية الظلامية والطبقات الكومبرادورية التابعة. ولا ينفي ذلك، بطبيعة الحال، أنّ هذا الوضع هو أيضا مسؤولية قوى اليسار التي لم تر ولم تعرف كيف تتعامل مع هذا التحدّي الذي لم يزل مستمرا دون أدنى ريب)).
قد يكون لهاتين الجهتين (بريطانيا والملكية المصرية) نوع من تحضير الساحة لتشكيل هذه الحركة أو الحساسية السياسية الدينية، واستغلالها في المستقبل لأغراض خاصة، تخص هاذين الطرفين، الاستعمار البريطاني والملكية في مصر. وكما فعلت الإدارة الأمريكية في دعم وتسليح التيارات الأصولية الجهادية في باكستان وأفغانستان واستخدمتهم لمحاربة الوجود السوفياتي والنظام الشيوعي القائم في أفغانستان، وتسهيل إسرائيل لقيام وتوسع منظمة حماس على حساب منظمة التحرير الفلسطينية – التي لا تتشكل من تيارات علمانية وديموقراطية كما يدّعي س. أمين، بل تيارات قومية – تقليدية. بالرغم من ذلك، فإنه لا يمكن فهم ظهور حركة الإخوان المسلمين في مصر، بما يسميه س. أمين، المؤامرة البريطانية – الملكية، أو قيام حماس بالفعل الإسرائيلي المحض إلخ.
الإسلام السياسي له وجهان، وجه أيديولوجي يحتكم اليه، وجانب حركي يفعل وله أثر في الواقع. أما الجانب الأول، الأيديولوجي فلا يمكن فهمه إلا بالانطلاق من الواقع المحلي، ودراسة نمط التدين الإسلامي السائد، وما هي التيارات المتحكمة في الإسلام وتوجيهه تاريخياً وحاضراً، وبالطبع دراسة الجانب السياسي وطبيعة الحكم ومنسوب العنف الممارس من قبل السلطة تجاه المجتمع. ويأتي التداخل بين الإسلام السياسي والأجهزة المخابراتية، سواء منها المحلية أو الغربية، في الجانب الحركي من الإسلام السياسي.
نعتبر ظاهرة الإسلام السياسي، والتي تجسدت لأول مرة مع تشكيل جمعية الإخوان المسلمين، هي ظاهرة وقوة اجتماعية وليست مؤامرة سياسية حيكت في دهاليز وزواريب الأجهزة الأمنية، وإن كانت هذه الأخيرة ليست بعيدة عن استغلال هذه الظاهرة السياسية – الدينية لأغراض أخرى هي كسر المعارضة وتمزيقها بشعار التخويف من الإسلاميين، دون أن تعمل هذه السلطات أي شيء للرفع من المستوى الثقافي والتربوي والتنويري لتحصين الشباب ضد هذه الظواهر المقلقة. لكن، التنويه لخطورة الظاهرة الإسلاموية لا يدفعنا للجوء إلى تفسيرها بنظرية المؤامرة، ولا يدفعنا إلى التقليل من المشروعية التي تملكها في الأوساط الشعبية المؤمنة بطريقة بدائية. والدليل على مشروعيتها هو دوامها (تقريباً قرن كامل) وعموميتها التي تمتد إلى معظم البلدان “الإسلامية”، وحتى التجمعات المسلمة في بلدان الاغتراب الغربية (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واكندا وأستراليا ونيوزيلندا).
وقد شهدنا الكثير من المناورات السلطوية في تشكيل أحزاب “كرتونية” تدور في فلك السلطة، وهي صناعة أمنية من ألف إلى ياء، الهدف منها تلميع صورة السلطة الاستبدادية الأحادية وإعطاء بعض الصبغة التعددية الكاذبة، كما هي الحال في طواهر الجبهات الشعبية التي تكثر في الأنظمة الجمهورية الشعبوية في العالم العربي والتي تدور في فلك السلطة وتحت رعايتها الأمنية والمالية[8].
إن تصاعد ظاهرة الإسلام السياسي التي بدأت في مصر، ثم انتشرت لاحقاً إلى باقي الدول العربية والإسلامية، لا يمكن فهمه إلا نتيجة إنهيار طروحات الإصلاح الديني الجريئة، وتحوّل معظم رجال الإصلاح الديني نحو السلفية المتوهبنة. ويعزى السبب في تراجع وإنهيار مشروع الإصلاح الديني إلى ظروف ذاتية تتعلق بالفكر الإصلاحي نفسه، وبالخصوص المحاولة الدؤوبة للتوفيق بين الحداثة والأصالة، والظروف الموضوعية وبالخصوص السياسية التي طرأت على المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى، التي أدت في المرحلة الأولى إلى سقوط الامبراطورية العثمانية وتوزيع ممتلكاتها بين بريطانيا وفرنسا، ووعد بلفور، من ثم إلغاء السلطنة (1923) والخلافة (1924) على يد مصطفى كمال أتاتورك.
وتمثّل حياة محمد رشيد رضا الطرابلسي المولد، أكبر دليل على بداية إنهيار الفكر الإصلاحي منذ الثلث الأول من القرن العشرين، فأغلب مؤرخي عصر النهضة العربي قسموا حياة الرجل إلى مرحلتين:
1- المرحلة الأولى، كانت متماهية مع طروحات الإصلاح الديني للشيخ محمد عبده.
2- المرحلة الثانية، بدأت مع كتابه ((الخلافة أو الإمامة الكبرى))، والذي صدر بعد عدة أشهر من إلغاء الخلافة العثمانية وقيام الجمهورية التركية العلمانية، فقد تحوّل رضا إلى السلفية القريبة من الوهابية، متخلياً عن الطروحات الإصلاحية التي أطلقها أستاذه محمد عبده.
وتمثّل حركة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 1928 في الإسماعيلية تكريساً وتجسيداً لهذا التحوّل في فكر الإصلاحية الدينية المستنيرة، وشكلت أو تحدي كبير ذد محاولات التحديث والنهضة منذ محمد علي باشا إلى ثورة عام 1919، وقد نجح هذا الرد الأصولي – السلفي، وبداية بروز المحور السعودي الوهابي في المنطقة، إلى وأد محاولات النهضة العربية باكراً. هذا لا يعني أن الفترة ما بين تشكيل حركة الإخوان المسلمين عام 1928 وبداية العصر الثوري والنظم الشعبوية العسكرية في بداية الخمسينيات خلت من الطروحات والكتابات النهضوية التنويرية، وإنما هذه الكتابات المتفرقة شكلت نوعاً من الارتدادات الاهتزازية باستعارة مصطلحات علم الزلازل. لقد حدث انتصار للخط الديني المتزمت، وانتقال فكر المجتمع إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة الاتكال على الدولة في حل الخصومات الاجتماعية والأيديولوجية بالأسلوب القسري.
الإسلام السياسي والعملية الديموقراطية
يصف س. أمين الطروحات التي تنادي بمحاولة إشراك الإسلام السياسي في العملية السياسية الديموقراطية، بأنها من نوع الخضوع للأمر الواقع. ويسمي هذه النظرة بـ ((النظرة الواقعية))، والواقعية هنا في لغة سمير أمين لها معنى سلبي، أي الخضوع لأمر واقع. يعتبر س. أمين أن ((المستقبل من وجهة نظر الاشتراكية العالمية هو لشعوب المنطقة كما للآخرين، وهو ديموقراطي وعلماني)). ونحن من جانبنا نقول أيضاً، ومن وجهة ديموقراطية وطنية، أن المستقبل هو للديموقراطية العلمانية، فهي التي تحوّل التاريخ المحلي من منحنى دائري إلى منحنى سهمي (كما يقول إشبنغلر). إن الاختلاف مع س. أمين هو أنه يشرط هذا التحوّل بقطع الصلة مع المركز الرأسمالي، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي بفك التبعية عن الرأسمالية، وهو يعني تأجيل المعركة الديموقراطية إلى حين تحقق فك التبعية، وبالمحصلة، ستكون النتيجة بقاء نظم الاستبداد، وتراجع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسبب النهب المنظّم للثروات، والإفقار المعمّم الذي سيقود يوماً إلى الحروب الأهلية وانفراط عقد الأوطان، وهو ما يحصل اليوم في العديد من البلدان العربية.
إن الرؤية الواقعية التي يدينها س. أمين، لا تعني الخضوع الأعمى للأمر الواقع، فتفسير الواقع كما هو قائماً يعني أن كل ما هو واقعي يصبح معقولاً، أي البدء بمعرفة الواقع عن طريق فعل تحليلي لا يخضع للحقائق المطلقة في التاريخ، وإنما يعتبر الحقيقة نسبية ومتطورة. يمثّل هذا خطوة متقدمة نحو محاولة جعل هذا الواقع يستجيب لمتطلبات عقلانية تداولية، تفتح لهذا الواقع مكانيات أفضل.
إن الحركات الإسلامية، رغم ما قلناه عن منشأها، باعتبارها ردود أفعال عنيفة على الحداثة – تثير تساؤلات جديرة بالنقاش، لكن المنهجية التي تتبعها في البحث عن إجابات لهذه الأسئلة لا تقدم أي حلول لهذه المشكلات، لا بل على العكس من ذلك تفاقم هذه المشكلات، فتصبح حركات الإسلام السياسي ليست جزءاً من الحل، بل جزءاً من المشكلة. إن السؤال الإشكالي الذي تطرحه هذه الحركات يختصر بالصياغة التالية (نريد أن نكون حداثيين، لكننا لن نكون أنتم أي الغرب)[9].
أي إننا نريد أن ندخل الحداثة، لكن دون التلوث من قريب أو بعيد بالثقافة الغربية وقيمها النسبوية والعدمية، كمن يريد القول، أريد السباحة في النهر لكن دون أن تتبلل ثيابي. بكلام أوضح، نريد الحداثة لكن حداثة متأصلة، حداثة متأسلمة[10].
إن الإدانة السياسية التي يوجهها س. أمين لكل محاولات إشراك الإسلام السياسي في عملية الانتقال الديموقراطي في العالم العربي والإسلامي تصب في صالح الأنظمة السلطوية التي تبرّر إحجامها عن توسيع أفق المشاركة السياسية في اتجاه المعارضات العربية التي قبلت في السير السلمي التدرجي نحو إصلاح الأنظمة السياسية، في أن المستفيد الأول من وراء هذا التوسيع هي تيارات الإسلام السياسي.
إن عدم الخضوع للأمر الواقع – وهو ما نفهمه ونمارسه – يتحوّل عند س. أمين إلى إهمال الواقع وتسفيهي وقسره على الخضوع للمقولات والتصورات الذهنية الأيديولوجية، والتي لم تنتج حين تم تجسيدها سياسياً سوى أنظمة قامعة للحريات.
إن المحاولات الحثيثة التي تقوم بها الحركات الوطنية الديموقراطية في العالم العربي، سواء تحت تمت باسم الأحزاب اليسارية والليبرالية والقومية أو باسم منظمات المجتمع المدني، تهدف إلى إشراك الإسلاميين في كافة الجبهات والتحالفات الهادفة لتعزيز التعاون والعمل الديموقراطي، وأيضاً، محاولة دفع هذه التيارات الإسلامية إلى مزيد من خطوات التي تزيد من جرعة القيم الديموقراطية والمساواتية بين المواطنين في برامجها. إن هذا العمل الوطني يصب في مصلحة تهدئة الأوضاع في المجتمعات العربية، ونزع فتيل الاحتقان والتشنج وتشجيع قيم الحوار والتوافق والتسامح وقبول الآخر بعيداً عن أجواء التخوين والتكفير الذي تلجأ اليه السلطات السياسية العربية والحركات الإسلامية الراديكالية، ولا تأتي هذه المحاولات كخضوع لإملاءات تيارات الإسلام السياسي، وإن كان الحوار يؤدي إلى نوع من التفهم للهواجس المشروعة التي تُطرح من قبل تلك التيارات.
الاستبداد المستنير
يتجه س. أمين في مقالته – التي نفند هنا بعض ما جاء في – منحاً أو وجهة تشرعن فيها نظرية الاستبداد السياسي بشكل تعميمي دون تخصيص، يقول: ((تنتمي الشعبوية الوطنية في مراحل التاريخ الأخيرة إلى عائلة المشاريع السياسية الحداثوية نفسها. وأشكال هذا النموذج عديدة (“جبهة التحرير الجزائرية” و”البورقيبية” التونسية و”الناصرية” في مصر و”البعثية” في سورية والعراق) إلا لأن اتجاهها العام كان واحداً. ومن الواضح أن التجارب المتطرفة – المسماة أنظمة شيوعية في جنوب اليمن سابقاً وأفغانستان – لم تختلف كثيراً في واقع الأمر. وهذه الأنظمة جميعها أنجزت الكثير ولهذا السبب، كانت تمتلك تأييداً شعبياً كبيراً ولهذا أيضاً، وعلى الرغم من أنها لم تكن ديموقراطية في الواقع، فتحت الطريق لتطور ديموقراطي ممكن في هذا الاتجاه)).
وكأن س. أمين يريد أن يقول (وبدون التصريح العلني بذلك)، فلنعد إلى النظرية الاشتراكية (رغم فشلها الفاضح)، والى تطبيقاتها الوطنية الهجينة في العالم العربي (الناصرية، البومدينية، البعثية، القذافية… إلخ) لأنها استطاعت وقف المد الأصولي الممثّل بتنظيم الإخوان المسلمين في نهاية العشرينيات، وهذا التمني لهو انحراف نحو المثالية (بالمعنى السلبي للكلمة)، من جانب مفكر يتبنى الحتميات المادية والتفسيرات الاقتصادية للتاريخ.
لكن، هل فعلاً هذه الأنظمة المُشاد بها من قبل س. أمين هي أنظمة “حداثوية”، وأوقفت المد الأصولي الإسلامي في العالم العربي أم على العكس ضاعفت من مخاطره؟
إن إطلاق صفة “الحداثوية” و”التقدمية” و”العلمانية” بالجملة على كافة الأنظمة الشعبوية الاستبدادية في العالم الثالث من قبل س. أمين، فيه الكثير من الطرح الأيديولوجي المتحيز، والذي لا يؤيده الحليل العلمي المستند إلى الوقائع الملموسة والأرقام المحسوسة. نحن لسنا بإطلاق ضد نظرية الاستبداد المستنير. فبعض التجارب التاريخية في المنطقة كانت ناجحة، وساهمت في نقل مجتمعاتها نحو تطور ديموقراطي. ومثال على هذه التجارب الناجحة، التجربة التركية التي قادها مصطفى كمال أتاتورك (1881-1938) وحزب الشعب الجمهوري في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى، وأوصلت تركيا أخيراً إلى الانخراط في الانتقال الديموقراطي. وفي العالم العربي لدينا التجربة البورقيبية التي ساهمت في تحرير المجتمع التونسي من رواسب الماضي الإقطاعي التقليدي، ودفعت المرأة التونسية إلى مصاف متقدمة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى. ولعل نجاح ثورة 14 جونفيي 2011، كان ثمرة الإصلاحات الكبرى للعهد البورقيبي، فالنتائج التربوية والثقافية، والثورة التشريعية التي حدثت في تونس مع دستور 1956، أدت إلى ارتقاء اجتماعي وثقافي وسياسي ملحوظ، بالإضافة إلى خلق نخب علمية وثقافية ممتازة. لكن هذه النخب العلمية والثقافية عجزت عن تحويل المفاهيم المعرفية والسياسية التي تتداولها في الكليات الإنسانية والاجتماعية إلى فضاء المجتمع والسياسة، بسبب دكتاتورية النظام الحاكم والحزب الأوحد والتي استشرت منذ بداية الثمانينيات[11].
إن نظرية الاستبداد المستنير، لا يمكن إلصاقها بجميع الأنظمة التي ذكرها س. أمين في مقالته الطويلة تحت عنوان كبير هو “التقدمية” الذي غالباً ما انتهكته هذه الأنظمة، منتهجة سياسات ترييف المدن وتصحيرها ثقافياً ومدينياً، ونحن نخشى على الكاتب الكبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمؤمن بالفرضية الشيوعية على خطى المفكر الفرنسي آلان باديو، أن يُظن به بعد قراءة مقالته هذه، أنه يوزع شهادات حسن سلوك على الدكتاتوريات العربية الشعبوية في العالم العربي، بحجة أنها تنتهج سياسات الممانعة والمقاومة ضد المحور الغربي “الرأسمالي” “الإمبريالي”، فليس أبعد من الحقيقة وصف الأنظمة التي دعمها السوفيات بقوة الأمر الواقع، أنه نوع من الاستبداد الحداثوي المستنير أو أنه يشكل أي نوع من المقاومة ضد الغرب والمركز الإمبريالي.
لقد وقع س. أمين في فخ بعض التنظيرات لنظرية الاستبداد المستنير، فالاستبداد الحداثوي لا يكون مستنيراً إلا إذا أنجز انتقالا هادئاً نحو توسيع المشاركة السياسية، وذلك عن طريق تحديث المجتمع وتحسين الشروط المعرفية والاقتصادية لخلق طبقة متوسطة واسعة تكون ركيزة للاستقرار الاجتماعي، وذلك بتحديث التعليم ووضع ميزانيات للتعليم العالي والبحث العلمي، ونشر الجامعات في العلوم الدقيقة والإنسانية في كل المدن الكبيرة والمتوسطة، تأهيل الكوادر العلمية والمعرفية لتكون الرافعة الأساسية لهذه النهضة، ونشر المراكز الثقافية والمكتبات في كل مكان. إن تعميم التعليم المجاني كما مارسته النظم الشعبوية، هو مجرد محو أمية لا أكثر، والمدارس التي انتشرت في كل ناحية وقرية دون تزويدها بالكوادر اللازمة والإمكانيات والخطط العلمية، تحولت مع الزمن إلى نوع من “الكتاتيب الحديثة” تنشر أساليب التلقين الببغاوي للطلبة.
إن هذا النموذج الاستبدادي الحداثوي لم ينجح إلا في تركيا وتونس، أما الدكتاتوريات الأخرى التي عددها س. أمين في مقالته الشهيرة عن الإسلام السياسي فهي في معظمها بعيدة عن الاستنارة، وإن كانت غير بعيدة عن القمع والوحشية في معاملة معارضاتها في الداخل والخارج. فالاستبداد موجود بالفعل، والاستنارة غائبة بالقوة، وسيادة الرأي الواحد، والحزب الواحد، والقائد الأوحد، والرئيس المؤبّد، لهو أسهل طريق لخلق معارضات استبدادية وإطلاقيه على شاكلة وثقافة أنظمتها، والى خنق المجتمع، وإبعاد الناس عن السياسة، وإدخال المجتمعات في حلقة جهنمية من العنف والعنف المضاد، لا يمكن الخروج منها إلا بتضحيات كبيرة، هذا إذا استطعنا الخروج.
أليست هذه الأنظمة الثورية المزعومة و”الحداثوية” عبارة عن ((استبداد شرقي خلعت عليه حلة ثورية تقدمية)) كما يقول ياسين الحافظ في كتابه ((الهزيمة والأيديولوجية المهزومة))[12]. وكأن س. أمين الماركسي غير التقليدي، يفضل اشتراكية تقليدوية وما قبل بورجوازية على النمط الناصري والبعثي، أي اشتراكية تشكل خطوة إلى الوراء قياساً من النظم البورجوازية والأرستقراطية التي كانت قائمة قبيل انبلاج الثورات العربية الحديثة، هذه الاشتراكيات التي وصفها الحافظ بحق على أنها ((تأخراكية)).
وما يثير الاستغراب، هو تراجع س. أمين عن مواقفه السابقة التي عبّر عنها في كتابه ((مذكراتي)) الذي صدر باللغة العربية عام 2006، حيث وجّه انتقادات قاسية للأنظمة السلطوية الثورية القائمة في العالم العربي (البعثية والناصرية والليبية واليمنية والجزائرية)، ومن هذه الانتقادات:
1– الرؤية البورجوازية للمستقبل.
2– المعاداة الأساسية للديموقراطية.
3– الفلسفة البراغماتية المبتذلة.
4– المغالاة في تقدير الدعم السوفياتي.
5– ودرجة من تغليب المصالح الآنية الرخيصة جعلتهم يعتقدون أنهم يستطيعون اللعب بالورقة الأمريكية، إذا اقتضت الحاجة.
أما عن تجربة أفغانستان الشيوعية، فهو يصفها بالخطأ القاتل من جانب السوفييت.
في زمن انهيار التجارب الإرادوية القوموية والشعبوية، والتي قمعت مجتمعاتها باسم مشروعات تنموية وجمعية لم تأت أبداً، يقوم س. أمين في مقالته الشهيرة عن الإسلام السياسي بإعطاء هذه التجارب صفة ((الاستنارة)) و((الحداثوية))[13]. يشعرنا س. أمين في مقالته فيما يخص الأصوليات الدينية والديكتاتوريات الشعبوية، وكأنه في حالة انضغاط بين عدوين، وعوضاً من اختيار الخيار الثالث الوطني الديموقراطي بالخروج الكامل عن الخيارين الأولين، فهو يختار – بحسب رأيه الأقل سوءاً – أي الانتصار للأصوليات القوموية الشعبوية العسكرية والأمنية بحجة أنها تحارب الامبريالية.
الصراع الطائفي في العراق
يقول س. أمين في مقالته عما حدث في العراق: ((وعلى أي حال، يمكن اتهام أنظمة البعث المتعاقبة بما فيها نظام صدام حسين نفسه في فترة انحطاطه، بكل شيء ما عدا قيامه بتأجيح الصراع بين السنة والشيعة)).
إنها شهادة حسن سلوك جديدة يعطيها س. أمين هذه المرة للنظام العراقي السابق الذي أوصل بلاده إلى هذه المحنة الأليمة بعد ثلاثين عاماً من السياسات الكارثية على المستوى الداخلي والخارجي. لكن الوقائع الدامغة أصبحت معروفة للعلن، تجعل الحقيقة في مكان آخر، غير الذي يضعها فيه س. أمين.
إن النظام التكريتي في العراق، كان النموذج الفعال لبقاء الطائفية متأججة تحت الرماد، عن طريق سياسات القمع الوحشي للمعارضين وتصحير الحياة السياسية وتهميش الثقافة ونشر الرعب والخوف في كل مكان، ودفع العراقيين إلى الاحتماء بانتماءاتهم الوشائجية الما قبل الوطنية، القبائلية – العشائرية والإثنية (عرب وأكراد) والطائفية (سنة وشيعة)، وليس انفجار العراق طائفياً واثنيا بعد الاجتياح الأمريكي عام 2003، إلا تجسيداً لهذه السياسات المشؤومة التي مارسها النظام العراقي السابق.
ولا بدّ أن س. أمين قد تخلى عن الماركسية والتحق بالأيديولوجية القومية الفاشية ليطلق وببساطة هذا القول. فشهادة رفاقه الماركسيين في العراق تأتي على الضد مما يقوله، حتى القوميين الديموقراطيون اعترفوا بالإساءات الكبيرة التي تسبب بها النظام العراقي السابق للمواطنة العراقية وللتعايش بين مختلف الإثنيات والطوائف في العراق.
ويسرد المفكر السوري الموسوعي جورج طرابيشي في كتابه ((هرطقات)) الجزء الثاني، تاريخاً طويلاً من الصراع السني – الشيعي، ابتدأ مع الحكم الأموي، ووصل إلى ذروته اليوم في العراق وسورية ولبنان وباكستان وأفغانستان.
يقول طرابيشي: ((خلافاً لأدبيات المؤامرة الخارجیة، التي تؤلف ثابتاً بارزاً من ثوابت الإیدیولوجیا العربية المعاصرة، فإن حوليات ابن الأثير تقدم لنا ثلاثة أمثلة على دلیل العكس، أي على كون الفتن الطائفية الداخلية ليست من صنع الأجنبي ولا من توظيفه، بل ھي التي توظف العامل الخارجي توظيفا فئویاً على مذبح ما نسمیه البوم بالمصلحة الوطنية أو القومية. والأمثلة التي تقدمھا حوليات ابن الأثير تغطي الحالات الثلاث من العلاقات التي عرفھا تاريخ الإسلام العربي مع العدو الخارجي الذي تمثل على التوالي بالروم والفرنج والتتار)).
ويستنتج بعد عرض طويل لتاريخ الصراع الطائفي السني – الشيعي قائلا: ((ماذا بمكن أن نستنتج من ھذا العرض المطول؟ إن الأمر لا یحتاج إلى كبیر اجتهاد: فما یجري الیوم في العراق، وإلى حد ما في باكستان، وما یمكن أن یجري في المملكة العربية السعودیة أو في دول الخليج أو في إيران، أو حتى في تركيا، فبما لو ارتفعت ید الدولة القامعة أو الضابطة، لا یدع مجالاً للشك في أن الطائفیة في الإسلام لیست حدثاً طارئاً ولا مصطنعاً بعامل خارجي: فھي قديمة قدم الإسلام نفسه. وحتى لا یبدو وكأننا نحمل المسؤولية للدین بما ھو كذلك، فلنقل إنھا ثابتة من ثوابت الإسلام التاریخي، بل هي الثابتة الأكثر استمرارية فیه، وإن خمدت جذورها أو اتّقدت تبعاً لتقلب موازين القوى الممسكة بمقاليد السلطة والدولة… والسؤال، كل السؤال: كتف السبیل إلى تسوية العلاقات المتوترة دوما، وإن الكامنة في ظاھرھا تحت الرماد، بین طوائف الإسلام؟)).
ويجيب قائلاً: ((أعن طریق الديمقراطية كما ینادي محمد عابد الجابري الذي طالب ذات یوم بسحب كلمة العلمانیة من قاموس الفكر العربي والاستعاضة عنھا بشعاري العقلانية والديمقراطية؟ ولكن كیف السبیل إلى عقلنة ودمقرطة العلاقات بین طوائف الإسلام – فضلاً عن العلاقات بین الملة الإسلامية والملل الدینیة الأخرى (ولا سیما منھا المسیحیة ولكن كذلك الصابئیة والإیزیدیة كما في العراق، والإحيائية كما في مثال السودان – ھذا إذا اكتفينا بالإسلام العربي ولم نتعدّه إلى الإسلام الآسيوي حیث ینطرح السؤال نفسه بالنسبة إلى البوذیة والھندوسیة والكونفوشية والطاویة، الخ)… أجل، كیف السبیل إلى عقلنة ودمقرطة العلاقات بین الطوائف الإسلامية المتكارھة علناً أو سراً أو تقية في ظل تغييب متعمد للعلمانية التي ما جرى اكتشافها وتطویرھا في مختبرات الحداثة الأوروبية إلا لتكون الدواء الشافي للداء الطائفي؟))[14].
الخاتمة:
نخلص إلى أن الحل ليس بالمفاضلة بين النظم الشعبوية الدكتاتورية والأصوليات الإسلاموية لصالح بقاء الأولى لرد خطر الثانية كما يقول سمير أمين، بل بالخروج من هذه الثنائية التي أصبحت تقبض كالكماشة على مصير العالم العربي وشعوبه، نحو الحل الثالث، وهو الدولة الوطنية الديموقراطية أو الدولة الوطنية الحديثة.
المراجع على الإنترنيت
سمير أمين ((هل يمكن للإسلام السياسي أن يتوافق مع الديموقراطية؟)) مقال باللغة الفرنسية، موقع المساء الكبير الفرنسي، تاريخ 14/02/2013.
سمير أمين ((الإسلام السياسي في خدمة التوسع الإمبريالي))، ترجمة إنتصار العزيزي (موقع الأوان، 08/12/2013).
سمير أمين ((الإسلام السياسي في خدمة التوسع الإمبريالي)) النسخة المعدّلة باللغة الفرنسية (مجلة أبحاث عالمية، العدد 83، تموز – سبتمبر 2008، ص: 9 – 35)، والموجودة على الرابط الالكتروني:
https://www.recherches–internationales.fr/RI83_pdf/RI83_Amin_pdf.pdf
Samir Amin “Political Islam in the service of imperialism” (Monthly Review newyork, december 2007).
[1]– العالم اليوم، حسب س. أمين، مؤلف من عالم المركز، المؤلف من الدول الصناعية الكبرى، والتي يمثّلها الثالوث المهيمن للإمبريالية التاريخية أي الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا الغربية واليابان، وعالم الأطراف المؤلف من الدول ذوات الاقتصاديات الخاضعة والمكملة للاقتصادات في دول المركز. وهذا العالم الطرفي هو بشكل عام متخلف، ويمكن تسمية اقتصاده مجازاً بالاقتصاد أو باقتصاد (السحت) – أي اقتصاد الفساد والرشوة – بحسب التعبير الذي صاغه المفكر السوري ياسين الحافظ.
لكن، أين يضع س. أمين اقتصادات دول مثل روسيا الاتحادية، الصين، البرازيل، الأرجنتين والمكسيك، والتي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة تحت سقف نظام اقتصاد السوق الرأسمالي. وإن كانت عملية الرسملة في الصين تتم تحت عنوان أيديولوجي براق هو “اقتصاد السوق الاشتراكي”، وبإشراف ورقابة الدولة التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني، إلا أنه لا يخفى على أحد، أن هذا الاقتصاد يتصف بنفس العلاقات الرأسمالية التي تتصف بها باقي الاقتصادات الرأسمالية في الغرب، مع فارق أساسي واحد استمرار الدولة الاستراتيجية في الصين وروسيا ـ وبشك أقل في اليابان – بالخصوص، وغيابها لصالح المراكز المالية الكبرى في الغرب.
بالطبع، هذا دليل آخر على عدم كفاية تحليل أي ظاهرة فقط بالمنهجية الاقتصادية.
اختلافنا مع هذا الطرح التأصيلي – الهووي، أولاً،أنه ينتهي بالقطيعة الحادة مع الحضارة الجديدة التي كانت أوروبا هي التي أطلقتها مستفيدة من كل التراكمات الحضارية السابقة، ومنها الحضارة العربية الإسلامية؛ وبالتالي، فهي تسجن الخصوصية العربية الإسلامية وتمنعها من التحاور والتثاقف مع التجارب الأخرى في العالم، وبالخصوص الحضارة الجديدة، حضارة الحداثة والتي لا يمكن الانفكاك عنها إلا في الغرق في التوحش والبربرية. وثانيا، أن تيارات الإسلام السياسي، وهنا تشترك معها مؤسسات الإسلام الرسمي، تسجن خصوصية المنطقة حضارياً وثقافياً في حدود الثقاقة والحضارة العربية الإسلامية مهمشين كل التجارب الحضارية الأخرى التي مرت على المنطقة قبل الإسلام.
يقول هانتغتون عن الصحوة الدينية: ((هذه الصحوة ليست رفضاً للحداثة، بل هي رفض للغرب وللثقافة الغربية العلمانية النسبية المتفسخة المرتبطة به. إنها رفض لما يطلق عليه “التسمم بالغرب” الذي يصيب المجتمعات غير الغربية، وهي إعلان استقلال ثقافي عن الغرب، إعلان كبرياء…)).
[2]– برهان غليون المحنة العربية الدولة ضد الأمة (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة عام 2003)، ص: 123.
[3]– عبد الإله بلقزيز العرب والحداثة: دراسة في مقالات الحداثيين (مركز دراسات الوحدة العربية، 2007، ص: 29).
[4]– إن الرد التقليدي لشيخ الأزهر أحمد الطيّب على رئيس جامعة القاهرة السيد في المؤتمر الدولي للتجديد الديني الذي انعقد في القاهرة في فبراير 2020، حيث تمسك شيخ الازهر بكافة المسلمات التقليدية للمؤسسة الدينية، ولنذكر بعضها: الأشعرية ستبقى عقيدة الأزهر الأساسية وهي التنظير للوسطية؛ لا تجديد عميق للتراث الديني الإسلامي بل كل مل يمكن عمله هو بعض الرتوش السطحية؛ التمسك بالخطاب التمجيدي للتراث؛ التصفيق الجماعي لخطاب شيخ الازهر يدل على غياب الروح العلمية الموضوعية على حساب التمسك بروح الجماعة الكهنوتية والعصبية داخل البيت الأزهري؛ رمي كل ما يمكن أن يحرج الخطاب الديني التقليدي في سلة السياسة، وبالخصوص في موضوع الفتنة الكبرى التي حدثت في ولاية الخليفة عثمان بن عفان، بينما يستمر الأزهر في رفض العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة والدولة عن الدين، وبالتالي، تحيّد السياسية عن التدخل في الشؤون الدينية وتأخذ المؤسسة الأزهرية استقلاليتها الكاملة في إدارة شؤونها الداخلية ومؤسساتها التعليمية؛ وأخيرا، فإن الشيخ أحمد الطيّب الذي وضّع الفتنة الكبرى على ظهر السياسة لم يمنع نفسه – وهذه عادة سيئة لدى رجال الدين عندنا – في الحديث في السياسة الدولية وبشكل يزايد على الخطابات المهووسة بالمؤامرة واعتبار المسلم في كل مكان وزمان ضحية دائمة من طرف الكبار في العالم.
[5]– مالك بن نبي ((شروط النهضة)) ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين (دار الفكر، دمشق 1986، ص: 152-155.
[6]– مازن بلال ((أزمة التفكير التراثي)) (الأولى للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى 2003).
[7]– ياسين الحافظ ((الهزيمة والأيديولوجية المهزومة)) (دار الطليعة، بيروت 1978، ص: 32).
[8]– تكثر التعليلات المؤامراتية لظاهرة الإخوان المسلمين بالخصوص، وظاهرة الإسلام السياسي بالعموم، وخاصة لدى كثيرين من الكتاب الماركسيين. فمنهم من يعتبرها ملء للفراغ الناتج عن دحر النزعة القومية العربية أمريكياً واسرائيلياً. هكذا، وبجرة قلم، تقتلع الظاهرة من كل شروطها المحلية، وأولها الشروط السياسية، وليس آخرها الثقافية التي في داخلها تشتغل أنماط التدين السائدة.
[9]– هذه الصياغة قدمها صاموئيل هانتغتون في كتابه ((صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي)) ترجمة طلعت الشايب (القاهرة، من منشورات سطور، الطبعة الثانية 1999)، ص: 168.
[10]– نجد الكثير من هذه الأقوال في كتابات المفكر اللبناني الأصل جيلبير أشقر، والذي يكتب باللغتين الفرنسية والعربية. حيث نراه يفسر ما يحدث في الشرق الأوسط وكأنه شريط أمريكي. في كتاباته تصبح الولايات المتحدة الامريكية أخطبوطاً لا يُقهر، كلّي القدرة والفعل، ويصبح – في هذه الحالة – الساسة والحكام في هذه المنطقة منزهين عن المسؤولية في كل ما يجري من مآسي وحروب وكوارث اقتصادية واجتماعية تحل في شعوب هذه المنطقة. وأحياناً نجد ج. أشقر يتباكى على نظام جمال عبد الناصر، لأنه استطاع تهميش الإخوان المسلمين عن طريق خطاب يناهض الاستعمار والامبريالية. وكأن المؤلف يريدنا الرجوع إلى سياسات الشعارات الزائفة في الستينيات، لوقف زحف الأصوليات الإسلاموية (انظر كتابه المعنون ((صدام الهمجيات))، دار الطليعة، 2002).
ونجد مثل هذه الآراء عند كاتب لبناني “مسيحي” آخر هو جورج قرم، حيث نجد في كتاباته مزيج من الأيديولوجية القومية العربية والنزعة القريبة من تيار الدراسات ما بعد الكولونيالية.
[11]– يقول عزمي بشارة في كتابه ((في المسألة العربية: مقدمة لبيان عربي ديموقراطي)) متحدثاً عن الاستعصاء الديموقراطي الحقيقي في كثير من الدول العربية على المستوى الاجتماعي، أن هناك ((بعض الحالات في الوطن العربي التي تقدّم مثلاً عكسياً تماماً. أي نجد حالات تتوفر فيها الظروف والشروط التاريخية، ولكن الدولة ترفض أن تؤدي دوراً باتجاه الانتقال إلى الديموقراطية والإصلاح بحجة أن المجتمع غير جاهز. خذ على سبيل المثال لا الحصر الحالة التونسية! هنا يصبح قرار الإصلاح من عدمه من قبل المؤسسة السياسية الحاكمة قراراً مصيرياً. في تونس يتوفر تاريخ من التجانس القومي والديني، وتاريخ للهوية الوطنية والحدود السياسية طويل نسبياً وسابق على التقسيم الاستعماري، وطبقة وسطى واسعة ومتعلمة نسبياً في ظل اقتصاد سوق…. ومع ذلك تقرر النخبة الحاكمة أن تدعم وتعزز النظام السلطوي وتمنع الحريات بحجة أن الشعب غير جاهز، وأن الديموقراطية سوف تأتي إلى الحكم بقوى سياسية أصولية غي ديموقراطية)) (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: 2007)، ص: 222.
[12]– ياسين الحافظ، المرجع السابق، ص: 30.
[13]– صحيح أن كثير من المفاهيم التنويرية والحداثوية قد تراجعت في ظل سيطرة الإسلام السياسي على الشارع، وخاصة حقوق المرأة وحريتها، والحقوق المدنية والشخصية. لكن الطريقة التي يستعملها بعض المتباكين، والحنين الذي يبدونه للأنظمة القومية في الستينيات لا تنفع في فهم ما جرى ويجري، ولا تستطيع أن تبني أفكاراً للمستقبل. فهذا الواقع الحالي، يجب البدء بقبوله على ما هو، والانطلاق منه للعمل على بناء واقع يكون ذو أفق أفضل للمستقبل، وأكثر انفتاحا في مختلف المجالات الاجتماعية. والأنظمة القومية السابقة ساهمت من خلال سياساتها التعسفية في بناء هذا الواقع الصعب الذي نعيشه اليوم، صحيح أنها أتاحت للمرأة بعض الحقوق، وخاصة في تقلد بعض المناصب، إلا أن نظام التعليم “المؤدلج” و”الأحادي” ساهم في خلق جيل لا يؤمن بالنقاش، ويتمسك بأفكاره وكأنها يقينيات، ولا يتسامح مع الآخرين إذا خالفوه الرأي أو المعتقد. فكيف لجيل كهذا أن يتقبل المساواة الفعلية مع المرأة، وأن يقبل بأن تقاضيه أو تحكمه امرأة.
[14]– جورج طرابيشي ((هرطقات: عن الديموقراطية والعلمانية والممانعة العربية))، الجزء الثاني، وعنوانه ((عن العلمانية كإشكالية إسلامية – إسلامية))، دار الساقي، 2006، مقالة العلمانية كإشكالية إسلامية – إسلامية، بند الطائفية كثابت دائم في التاريخ الإسلامي.
* وواضح للعيان أن فلسفة (إما.. وإما) هذه لا تلغي كل إمكانية لحل توفيقي أو لـ “طريق ثالث” فحسب، ولا كل إمكانية حتى لتوفيق لفظي من قبيل الشعار القائل بـ “تأصيل الحداثة وتحديث الأصالة” فحسب، بل تقيم أيضاً بين حدّي المعادلة علاقة صراع على الوجود وتنازع على البقاء بحيث يكون غياب أحدهما شرط حضور الآخر، بل حيث لا تكتب لواحدهما الحياة إلا بقدر ما يقتل الآخر ويستأصل شأفته من الوجود ليحتل فيه مكانه الذي لا يتسع، بحال من الأحوال، لاثنين….
** استندنا في نقدنا لسمير أمين لمقالة س. أمين ((الإسلام السياسي في خدمة التوسع الإمبريالي)) إلى الترجمة العربية التي أنجزتها انتصار العزيزي في جزأين (موقع الأوان، 08/12/2013)، وهي ترجمة عن الإنكليزية كان س. أمين قد نشرها في((المجلة الشهرية)) النيويوركية، ديسمبر 2007. وكذلك إلى النسخة الفرنسية المعدّلة المكتوبة بيد س. أمين نفسه (مجلة أبحاث عالمية، العدد 83، تموز – سبتمبر 2008، ص: 9 – 35).
وقد ظهرت المقالة لأول مرة عام 2006 في اللغة الفرنسية في كتاب المؤلف ((من أجل دولية خامسة)) (من منشورات دار الكرز الفرنسية، 2006)، الفصل الأول.




