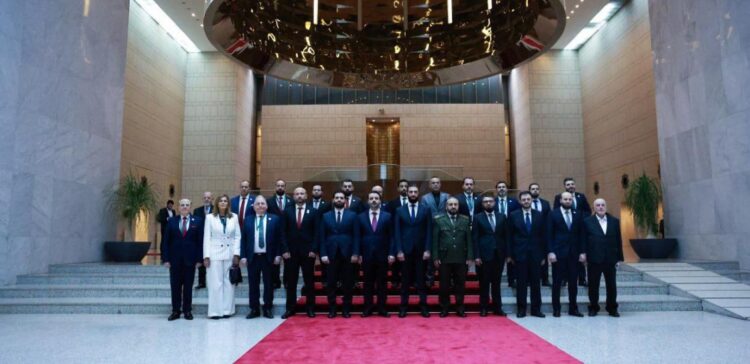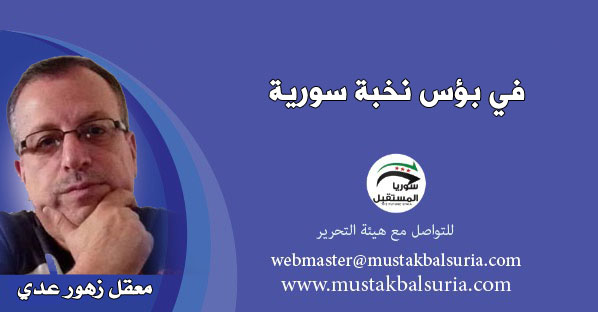الدولة العربية والهويات المتصارعة

بعض النظم والسلطات السياسية العربية الشمولية والتسلطية شكلت حالة “المجتمع ضد الدولة”، على نحو ما كان يوصف النظام السوري البعثي في عهدي حافظ الأسد وبشار الأسد، وذلك قبل الثورة الرقمية وبعض فوضاها وبعدها. ومصدر هذه الحالة هو الطابع السلطوي الاستبدادي والقمعي الوحشي لممارسة السلطة بالعنف، في ظل تركيبة حكم تعتمد على الطائفية الدينية والمذهبية، وهيمنة بعض من الطائفة العلوية، وفي ذات الوقت معهم بعض الموالين والمحاسيب السياسيين للسلطة من الجماعات الأخرى – المسلمين السنة وغيرهم من الطوائف الأخرى – وإقصاء وتهميش وقمع للغالبية والمكونات الأخرى.
دعم واتباعية من بعض الموالين من حزب البعث الحاكم، وتحالف من أحزاب هامشية لا قواعد اجتماعية لها، لأن النظام وسلطاته الأمنية والاستخباراتية كان يمارس القمع الوحشي على معارضيه، مع نظم للرقابة على الجموع الشعبية – من خلال عمليات التنصت والتقارير الأمنية على العاملين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وداخل العائلات والأسر والمساجد والمقاهي – حالة حصار رقابي شبه شامل لأنشطة وأفعال وأحداث ووقائع الحياة اليومية، ومعها عمليات القبض والتحقيق والاعتقال والتعذيب دونما ضمانات لمحاكمات عادلة أمام قضاء مستقل، حيث القضاء داعم للسلطة وأوامرها ونواهيها.
اعتمد النظام السوري – والعراقي والليبي – على الأجهزة الأمنية في إدارة النظام، بديلاً عن الإدارة السياسية والفكر السياسي الخلاق، وهو ما أدى إلى ظواهر موت السياسة في المجتمع والدولة والنظام. من ثم أدت تراكمات القمع وفوائضه إلى “رهّاب الخوف” المحلق فوق وحول حياة الأفراد والمجتمع ومكوناته، ومن ثم تجلت وجوه الحياة القلقة وغير الآمنة، وهي بيئة تدفع إلى الفساد في الإدارة والحياة اليومية.
السلطات القمعية و”رهاب الخوف” في سوريا وعراق صدام حسين وليبيا معمر القذافي أدت إلى ضعف سياسات الاندماج الداخلي والتكامل بين مكونات الجماعات الطائفية والمذهبية والعرقية في سوريا، والعشائر والمذاهب الدينية والقومية الكردية في العراق، وبين القبائل ومواقعها المناطقية في ليبيا، وبين قبائل الوسط النيلي في السودان تجاه جنوب السودان، والقبائل الأفريقية في شمال كردفان وإقليم دارفور، والبجا شرق السودان.
أدت هذه السياسات إلى تكريس ونمو الهويات الخاصة بكل مكون، أيا كانت طبيعته، في تركيبة كل مجتمع عربي. نمو وتمدد الهويات العرقية والدينية والمذهبية والقبلية والعشائرية أدى إلى إضعاف سياسة بناء الوطنيات ما بعد الاستقلال، حتى في الدول ذات الثقل التاريخي في المشرق العربي في العراق وسوريا!
أدت سياسات بوتقة الصهر إلى القمع الرمزي والمادي لمكونات الشعب في سوريا والعراق وليبيا، على نحو أدى إلى تفكك في بعض الأنسجة الثقافية والاجتماعية التي تشكل أساس علاقات مكونات كلا الشعبين الكبيرين. ومع تمدد هذه السياسات، وصف بعض الباحثين الفرنسيين الوضع في سوريا بـ”المجتمع ضد الدولة” في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، وذلك قبل الثورة الرقمية، ورحيل الأفراد إلى المجال العام الرقمي لإبداء آرائهم، وخاصة من هاجروا إلى خارج سوريا هرباً من القمع، وهو ما أدى ببعضهم إلى التركيز والترميز على البعد الطائفي في سجالاتهم وهجائهم الأيديولوجي للنظام، بقطع النظر عن اللغة المستخدمة والتي يضمر بعضها تحيزاتهم.
مرجع هذا التذرّي والتشظي والتفكك الهوياتي الجامع للمكونات الداخلية في غالب المجتمعات العربية قبل الثورة الرقمية والربيع العربي وبعده، أن الأجيال الجديدة من أبناء الرقمنة، ومعهم بعض الجماعات السياسية المنظمة، جاءوا من موت السياسة وغياب ثقافة وخبرات الدولة وأجهزتها البيروقراطية والأمنية والعسكرية. من ناحية أخرى، لم يكن لديهم قواعد اجتماعية داعمة لهم، واعتمدوا على الجموع الغفيرة غير المسيسة والمتذرية، وخطاب الشعارات العامة السائلة، ومن ثم افتقد غالبهم إلى سند حزبي أو جماعي منظم، والقدرة والكفاءة التنظيمية التي تجعلهم قادرين على التفكير السياسي والقدرة على التفاوض مع السلطات الانتقالية.
أدى ذلك إلى استخدام الواقع الافتراضي في التعبئة وبعض الحشد السياسي للتظاهرات، لكن دونما تنظيم محكم وقيادات سياسية قادرة على تقديم برامج وأفكار لمرحلة الانتقال السياسي، ومهارات المناورة والتفاوض وبناء تحالفات، والقدرة على اجتراح بعض الفجوات داخل تركيبة السلطات الانتقالية ومغازلة طموحات بعضهم داخلها.
في الحياة الرقمية، بدا ثمة انفجارات لآراء وانطباعات مرسلة للجموع الرقمية الغفيرة، وتناقضاتها وصراعاتها وتشظيها، ومن ثم أدى ذلك إلى فوضى في الحياتين الرقمية والفعلية، خاصة في ظل سطوة بعض الانطباعات الساذجة حول وقائع تاريخية وسياسية، وحول شخصيات سياسية بارزة، وهو ما خلق تناقضات واسعة بين الجموع الفعلية والرقمية الغفيرة.
الخطاب الرقمي حول مفاهيم الدولة والنظام والحرية بات يتسم بالخلط والتشوش والاضطراب والتوهان السياسي. بعض ما تم في العراق ما بعد الغزو الأمريكي أظهر وفجر وكرس التناقضات المذهبية والقومية والعشائرية، من خلال هندسة نظام ما بعد صدام حسين الذي خططت له الأجهزة الأمريكية – بريمر ومن وراءه من أجهزة -، وأدى إلى مشكلات جديدة وعسر في عمليات بناء المؤسسات السياسية، وإلى هيمنة المذهبية الدينية والقومية – الكردية – على تشكيل وإدارة النظام، وإلى انفجار أشكال من الفساد السياسي لبعض السياسيين الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي، واعتماد بعضهم على مراكز القوى الدينية المذهبية التي بات لها نفوذ سياسي كبير على بعض السياسيين وعلى قواعدهم الشعبية الدينية والمذهبية، وتوظيف بعضهم للمظلومية التاريخية للمذهب الذي يمثلونه – الشيعة في العراق -، وبعض هذه المظلومية صحيح، إلا أن ذلك أدى إلى تديين ومذهبة السياسة في العراق، ومن ثم إلى هيمنة بعض رجال الدين والمراجع المذهبية الكبرى على الحياة السياسية والاجتماعية.
في سوريا، أدى تهميش الأغلبية السنية إلى تديين الصراع مع نظام البعث الأسدي، وهو ما أدى إلى تدمير حماة، وظلت في الذاكرة السياسية علامة على الصراع المستمر مع النظام، والمجتمع ضد الدولة.
في السودان، كان تهميش الجنوب قبل استقلاله يرتكز على أسس قبلية وعرقية ودينية من القبائل العربية في الوسط النيلي، وبين المكونات الأفريقية القبائلية، وهي تمييزات أدت إلى ضعف قدرات وملكات النخب السياسية ما بعد الاستقلال على دمج بعض هذه المكونات المتعددة في قلب النظام ومؤسساته. والأخطر أن تجارب الحكم السوداني وتقلباته، ما بين ثنائية المدنيين والعسكريين الدائرية على نحو مستمر منذ الاستقلال، أدت إلى عدم تبلور حياة سياسية نشطة، والأهم بناء موحدات جامعة تتجاوز هويات القبائل والأعراق ومكونات الشعب السوداني، ومن ثم عدم تبلور مفهوم الأمة تاريخياً، نظراً لعدم توافر شروطها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التاريخية والمستمرة عبر العمليات السياسية الإقصائية.
الدولة الأمة – على المثال المصري والمغربي، ونسبياً تونس – لم يتشكل في حالة سوريا والعراق ولبنان والسودان وليبيا وغالب البلدان العربية، رغم عراقة الثقافة والتاريخ في المشرق العربي.
مرجع ذلك هو سياسة “اللاسياسة”، وقمع الحريات العامة وانتهاكات الحريات الشخصية، وتجسد الدولة في النظام التسلطي، وكليهما في الحاكم عند قمة النظام، وبعض مراكز القوة حوله، وأيضاً هشاشة المؤسسات السياسية وسلطات الدولة لصالح الحكم عند القمة السلطوية المستبدة.
بدت الأحزاب السياسية في غالب هذه البلدان محض إيديولوجيات وخطاب سياسي مرسل في الفراغ، ولا تستند إلى قواعد جماهيرية، سواء الأحزاب الحاكمة أو الأحزاب المعارضة الموالية أو المحجوب عنها الشرعية السياسية والقانونية. كانت بعض أيديولوجيات هذه الأحزاب منفصلة عن مشاكل القوى الاجتماعية المختلفة، وأيضاً بعضها كان يرتكز على بعض الجماعات أو الأعراق أو القوميات في البلدان العربية الانقسامية، ومن ثم كانت جزءاً من إعاقات تبلور هويات جامعة في هذه البلدان، ومن ثم تعثرت عمليات بناء جوامع وطنية مشتركة عابرة للانتماءات الأولية في هذه المجتمعات المشرقية العريقة – سوريا والعراق – ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الغربي.
أدت النزاعات بين الأنظمة العربية إلى توظيفها سياسياً من السلطات الحاكمة في التعبئة السياسية والضبط والقمع السياسي الداخلي، وفي تنشيط مفهوم الوطنية، ومن ثم إعاقة تبلوره على أسس ديمقراطية وتمثيلية لكل المكونات الداخلية – الدينية والمذهبية والطائفية والعشائرية والقبلية والعرقية والقومية واللغوية – من ثم باتت مسألة التكامل الداخلي هي أبرز معالم تشظي المجتمع وانفجار تناقضاته ونزاعاته الهوياتية، وهو ما ظهر في الحروب الأهلية.
ساعد على هذا التشظي الثورة الرقمية، وانفجار تسونامي رقمي من الجموع الرقمية الغفيرة، والأخبار السوداء الكاذبة من المكونات من بعضها على البعض الآخر، ومن ثم بروز ظواهر ثقافة كراهية الآخر داخل ذات المجتمع، وخاصة مع حمل هذه الأخبار السوداء والهجاءات على التحيزات الدينية والمذهبية والعرقية… إلخ. من ثم بات التشظي والتذري محمولاً على الحياة الرقمية ومؤثراً على الحياة الفعلية.
من هنا، لا بديل تاريخي وسياسي أمام مجتمعات ودول ما بعد الكولونيالية إلا بناء مؤسسات تمثيلية ودولة قانون وحريات وفصل للسلطات الثلاث الفاعلة وتوزيع للقوة بينها، ونظم تعبر عن مصالح الجماعات التكوينية – الدينية والمذهبية والعرقية… إلخ – وتساعد على بناء موحدات جامعة عابرة للهويات الفرعية في كل مجتمع ودولة في عالم عاصف بالتغير والصدمات.
المصدر: الأهرام